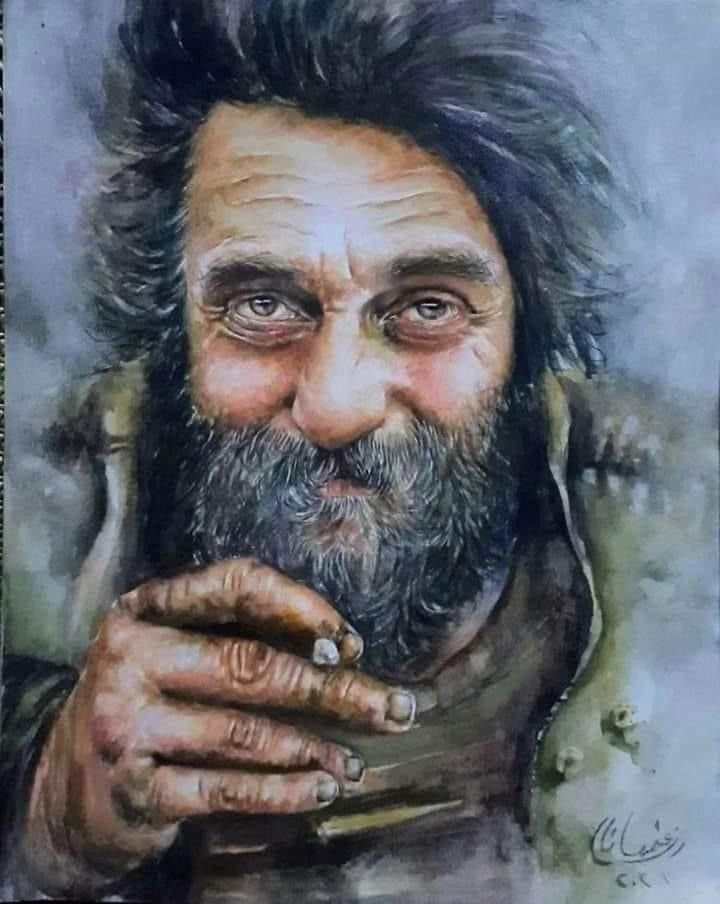الصحيفة الإخبارية – Corporate Communications
اقتصادية ثقافية-
التصنيفات

أدب الاعتراف .. للعرب نصيب في البوح والهمس
يعشق فصيل من بني جلدتنا التماهي مع الآخر، بجلد الذات وإنكار أي نصيب لها في الإبداع، فالشرق مكبل بقيود التراث التي كرست الرجعية والتخلف، نقيض الغرب السابح وراء أفكار التقدم، والمندفع بقوة نحو المستقبل في جميع الميادين، وعلى مختلف الجبهات والأصعدة. وتذهب أقلام إلى نسبة الفضل للغرب في كل شيء، فالعرب بلا بصيرة ولا حصافة وبغير حجى ولا نباهة. وإن حدث وأبدع العقل العربي، في نظر هؤلاء – فعادة ما يكون تقليدا واتباعا لا أصالة وإبداعا.
شاع القول عن نسبة أدب الاعتراف إلى الثقافة الغربية، فهو من الآداب الحديثة في العالم العربي، والسبب وراء ذلك عائد إلى القيود التي تفرض على المبدع البقاء أسير أطر محددة وقوالب معينة لحظة الكتابة، ما حال دون قدرة العرب على الكتابة في هذا الصنف الأدبي. فأي محاولة للتأليف في أدب الاعتراف سرعان ما تقمع متى تذكر صاحبها أعراف القبيلة وسلطة المجتمع، فالقاعدة تظل دوما وأبدا هي، “النحن” قبل “الأنا”.
يفتقد هذا الكلام الدقة في أكثر من جانب، بدءا من نشأة هذا الأدب الذي لم يظهر دفعة واحدة، فقد امتزج مع أصناف أخرى، مثل المذكرات واليوميات والرسائل والسيرة الذاتية، حتى قيل إن “أدب الاعتراف خرج من رحم فن السيرة الذاتية”، فكاتب السيرة يكشف عن خبايا نفسه، فما يكتب يتم بالصراحة والشجاعة التي تفرض عليه الخروج من ذاته، ويقف من نفسه موقفا موضوعا، بحيث لا يخشى مواجهة حقائق حياته مهما علت أو صغرت قيمتها.
في تعريف قاموس أكسفورد للسيرة الذاتية نقرأ بأنها “كتابة إنسان لتاريخه، أو قص حياة إنسان بنفسه”، ومن التعاريف أيضا قولهم إنها “كشف عن الشخصية أثناء عملية الصراع التي تقوم بين شعور الكاتب بذاته، وموقف المجتمع منه، ومدى خضوع أحد الطرفين للآخر”. تعريف يوشك أن ينطبق على أدب الاعتراف، ما يؤكد صعوبة فصل هذا الشكل الأدبي عن السيرة الذاتية، وإن كانت بدورها قد اختلطت، حتى بدايات القرن 18، مع المذكرات التي كانت تطلق على أعمال سميت لاحقا سيرة ذاتية. يبقى الفارق في المضمون فقط، حيث تركز المذكرات على الأحداث الخارجية، فيما تهتم السيرة بخبايا النفوس ودواخلها.
تفيد الروايات التاريخية أن أولى المحاولات في فن السيرة قام بها الرومان، وتستدل بكتاب “الاعترافات” للقديس أوغسطين الذي يحكي فيه عن حياته، ورحلة انتقاله نحو المسيحية. وفي التراث العربي، ينعقد الإجماع على عد مؤلف “الاعتبار” لصاحبه أسامة بن منقذ الكناني، الملقب بمؤيد الدولة “الدولة الأيوبية”، أقدم سيرة ذاتية، حررت أواخر القرن 12 الميلادي “1187”، وظلت مخطوطا، في مكتبة الاسكوريال، إلى حين تحقيقه على يد المؤرخ اللبناني فليب خوري في 1930.
يذكر أن المؤرخ عبد الرحمن ابن خلدون كان من أوائل من كتبوا ترجمة ذاتية عن أنفسهم، قريبة من مفهوم السيرة الذاتية بالمعنى الحديث، حيث عرض فيها تفاصيل حياته، بناء على التدرج الزمني، منذ طفولته حتى آخر أيامه، وما عاشه خلالها من حوادث، واختار لها عنوان “التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا”. كانت هذه السيرة في الأصل مجرد ملحق، ذيل كتاب “العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر” قبل أن يطور الرجل “مختصر السيرة” ذاك إلى مؤلف.
بهذا يكون أدب الاعتراف حاضرا في التراث العربي، بصور مختلفة حسب الأزمنة، فعلى سبيل المثال لا يكاد يخلو سجل كبار الأدباء من اعترافات، بشكل مباشر من خلال سردها في السيرة الذاتية أو بشكل غير مباشر على لسان بطل من أبطال رواياته، حتى إن حاول كثير منهم إنكار ذلك. كما نجد في رواية “هموم الشباب” حيث نقرأ “كل محاولة للربط أو المقارنة بين بطل هذا الكتاب، وبين مؤلفه مصيرها الإخفاق الشنيع”. سرعان ما يكتشف القارئ الحقيقة، مع تقدمه في صفحات الرواية، حين يعترف الكاتب على لسان البطل، فيقول، “صرت أحيا كل شيء بوساطة الكتب، ولا أستطيع أن أحيا بنفسي… لا أكاد أعبر عن أي شعور لدي إلا مقرونا بفقرات طويلة لمؤلفين”.
استعان الأديب إبراهيم المازني بالحيلة ذاتها لبث اعترافاته، في عدد من أعماله الروائية، فتوارى وراء قناع البطل إبراهيم. روايتا “إبراهيم الكاتب” و”إبراهيم الثاني”، ليكشف عن أسرار وحقائق مجهولة لجمهور القراء، مع التملص من ذلك بقوله، “لست أحتاج أن أقول إني لست بإبراهيم الذي تصفه الرواية، فما تعجبني سيرته ولا مزاجه ولا التفاتات ذهنه… ذلك أنه يتناول الحياة باحتفال، وأنا أتلقاها بغير احتفال، وهو يعيش للدنيا وأنا أفتر لها عن أعذب ابتساماتي”.
عقبة تجاوزها مع التقدم في العمر، فقد ذهبت جرأته بعيدا في سيرته التي حملت عنوان “قصة حياة”، فيعترف مثلا بالخجل الذي يرادوه وسط الجماعة، “ليس أبغض إلي، ولا أثقل على نفسي، من أن أراني في حشد كبير من الناس… ولا أعرف سببا لهذا النفور، لكنني أحس – إذا جالست قوما فيهم من لا أعرف – كأن يدا تأخذ بمخنقي”. وفي سياق آخر يعترف كاشفا عن سرائر أسرته، “أحسست أني فقير، فأرهف ذلك إحساسي… فزعت شيئا فشيئا إلى الانقباض عن الناس، واتقاء الخوض معهم فيما يخوضون، ما يستدعى نفقه، وتكون فيه كلفة”. ويحكي عما خلفه ظلم أخيه من أثرة في نفسه، “أخاف الناس وأنظر إليهم شذرا. وإذا كان الأخ الأكبر يجني على إخوته وأمهم وجدتهم، فما ظنك بالغريب”.
يظهر أن منكري أدب الاعتراف عربيا، بسبب القيود الاجتماعية والأغلال الثقافية، لم يطلعوا على كتاب “الخبز الحافي” للروائي المغربي محمد شكري، ولم يقرؤوا سيرة الأديب اللبناني ميخائيل نعيمة، بعنوان “سبعون” – ثلاثة أجزاء – حيث تكلم الرجل بكل جرأة وشجاعة عن موضوع المرأة الذي كان وقتئذ “طابو” بالنسبة إلى المجتمع. وهو المدرك كما قال إن “الكاتب بتسجيل حياته يجعل نفسه كبيت مبني من زجاج ليراه الجميع من الخارج”.
فكشف في سيرته عن مغامراته في العواصم الغربية، فعلى سبيل المثال كشف عن حقيقة لقائه في باريس بالفرنسية مادلين، “الإنسان في مرة أخرى انتصر على الحيوان”. واعترف صراحة بنظرته تجاه الأنثى، “تبين لي من علاقاتي مع النساء، أنني لم أولد لأكون بعلا لامرأة، وأبا لعدد من البنات والبنين. فعملي في حياتي هو أكثر من تجديد النسل الذي يقوم به الملايين من الناس”. ولم يتردد نعيمة في فضح نواقص شخصيته وعيوبها، في أكثر من موضع في السيرة، “إنني في علاقاتي مع الناس حريص كل الحرص على عزلتي. فالعزلة حاجة في نفسي مثلما الخبز والماء والخواء حاجة في جسدي. ولا بد لي من ساعات أعتزل فيها الناس لأهضم الساعات التي صرفتها في مخالطة الناس”.
أي جاحد بعد كل الذي قيل يمكنه أن ينفي وجود أدب الاعتراف في التراث والثقافة العربيين، ثم كيف تستثنى الثقافة العربية وحدها، والأديب المصري محمود تيمور يعترف – كأنه يؤسس لقاعدة – بأن “الكاتب إذ يدعى أنه أقل الناس تحدثا عن نفسه، نراه أكثرهم ثرثرة وإفشاء لأكتم أسراره، فكل ما يخطه قلمه صحائف ناصعة يترجم بها عن إحساساته وميوله، ورغبات نفسه، ودفائنها، بيد أن الكاتب في عمله الأدبي يتحدث عن نفسه وهو لا يدري أنه يفعل”.
مشاركات

الامتثال في المصارف: ركيزة للثقة والاستقرار المالي

الجريمة المالية: التهديد الصامت للاقتصاد والمجتمع

غسل الأموال: الجريمة الخفية التي تهدد الاقتصاد العالمي

تمويل الارهاب : التهديد الخفي للامن العام

Digital twin risks

6 إنجازات مناخية جعلت 2022 عاماً مفصلياً لخفض الانبعاثات

خمسة عشر دولة مضطرة لتغيير عملتها عقب وفاة الملكة

كيف ظهرت فكرة البنوك المركزية حول العالم؟

الائتمان التجاري والائتمان المصرفي